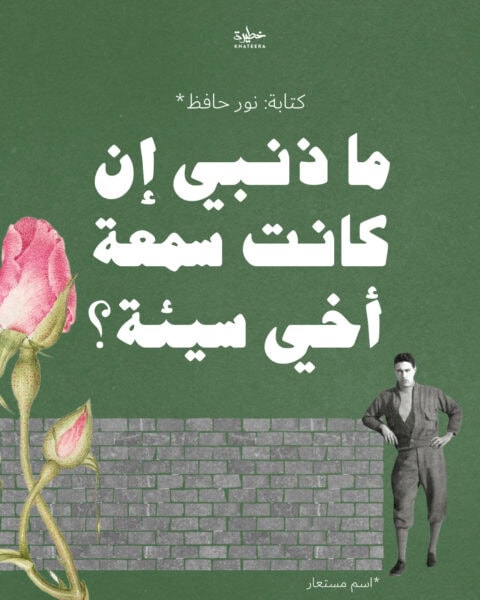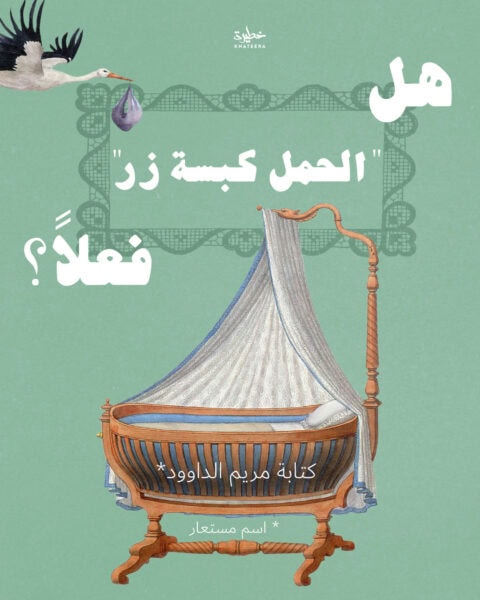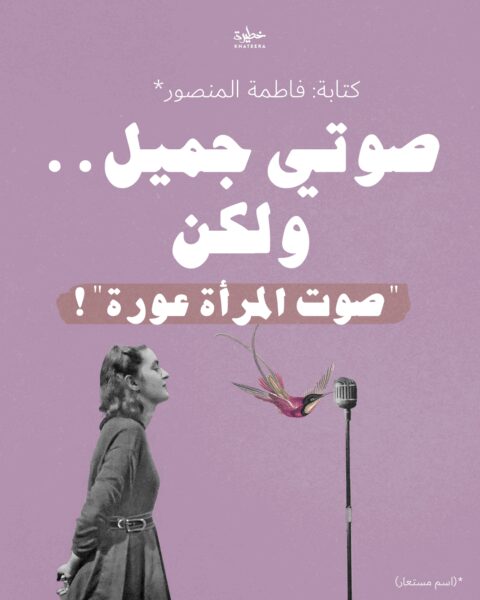كنت في السابعة عشر من عمري حين أعدّت جدتي الشاي وجلست معي أنا وأمي في مطبخها بإحدى الأرياف التونسية. أذكر صدمتي عندما سمعتها تروي قصة جارتنا وصديقة العائلة أم أحمد ناقلةً ما كانت تقوله لزوجها كل ليلة: البس الواقي الذكري وإلا لا!
أفنت أم أحمد عمرها في الحقول وخدمة الأرض حيث تقاضت أجراً هزيلاً وواجهت طرقات وعرة أودت بحياة عشرات الفلاحات المهمّشات مثلها. وبعد أن رُزقت بثلاثة أطفال توأم ووهبتهم من الحب كل ما يمكن أن تهبه أي أم، قررت التوقف عن الإنجاب، فبدأت ترفض العلاقات غير المحميّة رفضاً قاطعاً آمرةً زوجها: البس الواقي الذكري وإلا لا!
خجلت أمي: الطفلة صغيرة على هذه المواضيع.
فردت عليها جدتي: الجيل هذا مش جيلنا… لازم تعرف. يا بنتي، اسمعيني، الواقي الذكري مش حاجة تستحي منها البنت، بالعكس، هذا يدلّ على وعي ومسؤولية. حتى في العلاقات الزوجية، ينصح الطبيب باستخدامه لحماية الطرفين من الأمراض أو لتأجيل الحمل.
ثم أكملت شرحها بأن الكثير من الرجال يمتنعون عن استخدام الواقي الذكري معتبرين أن ارتداءه يمسّ رجولتهم ويقلّل من هيمنتهم داخل العلاقة، بينما يرى البعض الآخر أنه رمز للمرض وقلة الثقة. أما آخرون فيتحججون بأنه يقلل المتعة.
يبلغ معدّل استخدام الواقي في الدول العربية حوالي 3٪ فقط بين المتزوجات في سن الإنجاب، ما يعني أن مسؤوليّة منع الحمل تقع في معظم الأحيان على عاتق النساء وحدهن.
كانت تلك أوّل مرّة أسمع فيها عن الواقي الذكري. ورغم أنني ذهلت في بادئ الأمر، إلا أنني أحسست لاحقاً بفخر لا يوصف. فجدّتي التي لم تجلس يوماً على مقاعد الدراسة كانت تدافع عن النساء وحقوقهن بجرأة كبيرة: كوني واعية، لا جاهلة. كوني محميّة، لا ضحيّة. الوعي لا يخدش الحياء.
بفضلها صرت أقوى بالفعل، وكأنّ كلماتها حفرت فيّ شيئاً لا يزول. ولا أزال أبتسم كلّما سمعت كلمة «البس».