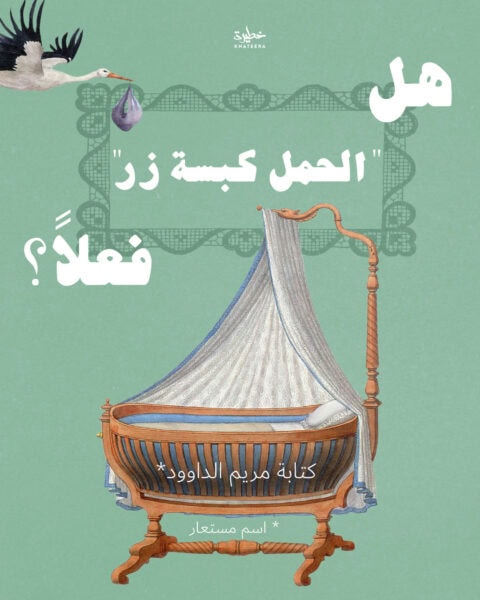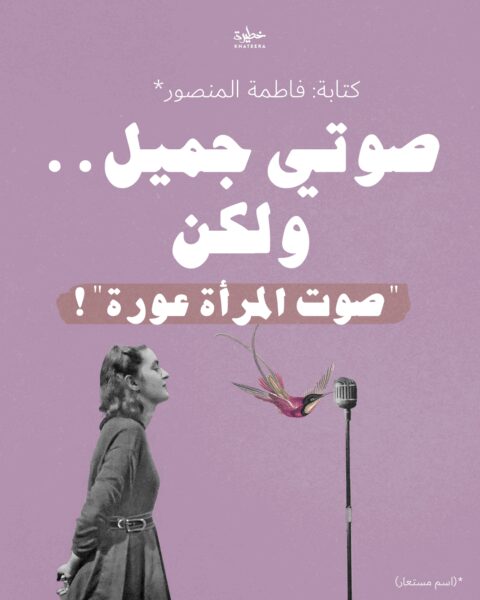نظرتْ إليّ بعينين مليئتين بالشفقة. اقتَربتْ، ربّتتْ على كتفي وهمَستْ بأسى: “أنا آسفة لأنك مررت بهذه الصدمة”
أغضبتني طريقتها. لكن ما استفزني أكثر كان تعليقاً آخر يفتقر إلى أي ذكاء عاطفي: “إزاي؟ إزاي متضايقتيش لما قطعولك حتّه من جسمك؟ إزاي وافقتي على ده؟” توالت عليّ تعليقات مشابهة أثناء مشاركتي في فعالية نسوية في القاهرة.
أتفهم أن تعليقات كهذه تنبع من نية طيبة و من غضب مشروع على مجتمع لا يزال يتسامح مع الختان، ولكن لماذا يُملين عليّ ما يُفترض أن أشعر به رغم أنهن لم يعشن ما عشته؟
في تلك الفترة، لم أكن غاضبة من ختاني، بل من طريقة النظر إلي كضحية لم تدرك بعد أنها ضحية. هل كنت ضحية؟ ربما، لكن ليس كما يتخيّلن.
تعرضت قرابة 230 مليون امرأة حول العالم للختان. ورغم تجريمه في مصر منذ عام 2008، لا تزال هذه الممارسة منتشرة ويصعب القضاء عليها. تشير الإحصاءات إلى أن 92% من النساء المصريات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية بين 15 و49 قد خضعن للختان.
في مدينتي، بإحدى محافظات الصعيد، كان الختان يسمى بـ “الطهارة” ويُحتفى به كما لو كان زفافاً. كل الفتيات كنّ ينتظرنه ويتوقعنه. كنتُ في السابعة من عمري عندما بدأتْ أمي تلاعبني بالكلام وتتحايل عليّ:
“هتاخدي حقنة وبس.” وفي لحظات أخرى خاطفة، كانت تهمس: “هيقطعوا حتّة من تحت!” ثم، في اللحظة الأخيرة، قالت لي والطبيب واقف على سُلّم البيت: “اقلعي الأندر بسرعة.” لم يكن هذا ما اتفقنا عليه.. لم يكن من المفترض أن يقترب الطبيب من تلك المنطقة.
لكن تحت ضغط الموقف، أذعنت.
دخل الطبيب. ضحك معي لثوان، ثم لم أشعر بشيء.
استيقظتُ وأنا أشعر بدوار، وبيتنا يعجّ بالضيوف. زارتني العائلة كلها. أغرقوني بالشيبسي والعصير والشوكولاتة. كل ما طلبته كان يُلبّى فوراً، لدرجة أن بنات خالتي شعرن بالغيرة. أردن ما حصلتُ عليه من “دلع”.
مرّ الأمر بسلام، وكانت ذكرى حلوة في نظري لوقت طويل من حياتي، إذ لم أشعر بالألم ولو للحظة. تذكرت فقط الدلع والاحتفاء… إلى أن بدأتُ أهتم بجسدي وأفكر بمستقبل حياتي الجنسية.
يُعتبر ختاني أقل ضرراً من أنواع أخرى، فما قُطع كان قطعة صغيرة بحجم الزبيبة، دون استئصال كامل للبظر، ودون إغلاق أو تضييق للمهبل. ولكن رغم ذلك، لا يزال تشويهاً قادراً على التأثير على متعتي وعلاقتي مع جسدي.
بدأتُ أقرأ عن عمليات ترميم البظر، لأكتشف أنها مكلفة وصعبة المنال. هل يُعقل أن أدفع كل هذه التكاليف فقط لأحاول استعادة ما شوّهته عائلتي في لحظة؟ قهرتني الفكرة، وشعرتُ أنني ربما لن أحظى أبداً بحياة جنسية مُرضِية.
جرّبتُ أن أمارس الإمتاع الذاتي لأتأكد من إمكانية شعوري باللذة، واكتشفت أن الأمر ليس بالسوء الذي تخيلته. فباستثناء بعض المواضع التي عجزتُ فيها عن بلوغ النشوة، تمكنتُ من بلوغها في مواضع أخرى.
رغم ارتياحي للفكرة إلا أن شعور النقص لم يُفارقني. عندها فقط، انفجرتْ داخلي كل مشاعر الغضب. غضبتُ لأن من أفسدوا أجسادنا، فعلوها باسم الفضيلة.
غضبتُ من أبي، الذي لو استطعت مواجهته، لقلت له:
هل كنتَ بهذه السذاجة لتصدق أن قطع جزء من جسدي سيحميني من الانحراف؟
غضبت من تطبيع المجتمع. من تلك الجريمة التي تحدث كل يوم بمباركة، وضحك، واحتفال وخداع. ولأن أجسادنا دوماً محل تشكيك… لا تُحترم ولا يُؤمّن لها.
أغضب اليوم، وبوضوح، ليس فقط من الختان، بل من الصورة النمطية التي تفترض أن تجربتي لا تُعدّ “حقيقية” إلا إذا كانت غارقة في الألم، والدم، والصراخ، وأن لأحد ما الحق أن يُملي عليّ كيف يجب أن أشعر.
اليوم آمل وأنتظر أن يكون العزاء من ذلك كله في التصالح المستمر مع جسدي وفي إيجاد شريك داعم، يسمعني ويهتم لأمري ولمتعتي لنستكشف معاً طرقاً جديدة تمكنني من الوصول إلى لذة مكتملة خالية من أي شعور بالنقص.